من هم “جهاديو” الضواحي؟ إنهم من الشباب العربي من أبناء الجيل الثالث والرابع الذين فتحوا أعينهم في أوروبا، ودرسوا في مدارسها، وعاشوا في الأحياء المهمشة لمدنها الكبيرة.
أغلب المتورطين، أو المنفذين لهجمات إرهابية في أوروبا، خلال العقدين الماضيين، هم هذه الشريحة من أبناء “الضواحي”، وغالباً ما يكونون من أصول عربية، ولدوا وترعرعوا في ضواحي المدن الأوربية الكبيرة التي تشبه “الغيتوهات”.
من محمد مراح، الشاب الفرنسي من أصول جزائرية الذي هاجم مدرسة يهودية في مدينة تولوز الفرنسية عام 2012، إلى منفذي هجمات باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مروراً بأحداث “شارلي إيبدو”، وكلهم من أصول مغاربية، بدأ الباحثون والمختصون في دراسة ظاهرة الإرهاب الأوروبي “الإسلامي” يحاولون رسم “بورتريه” لـ “الجهاديين” الجدد، أو ما بات يطلق عليهم الإعلام الغربي لقب “جهاديي الضواحي”.
ما يجمع بين كل هؤلاء المتورطين في أعمال توصف بالإرهابية، أو المنفذين لأعمال تحمل التوصيف نفسه، أنهم شباب في مرحلة عمرية بين العشرين والثلاثين عاماً، وأغلبهم من أصول عربية، وغالباً مغاربية، يتحدرون من أسر استقرت في أوروبا قبل ثلاثة عقود أو أربعة، بحثا عن العمل وحياة أفضل في أوروبا.
القاسم المشترك الثاني بين هؤلاء “الجهاديين” هو أنهم أصحاب تعليم متوسط أو متدنٍ، وطفولة قاسية، وهو ما يجعلهم عرضة للبطالة، وعدم القدرة على الاندماج داخل مجتمعاتهم. وغالباً ما يؤدي انقطاعهم المبكر عن الدراسة إلى الخروج إلى الشارع مبكراً، حيث يكونون ضحية للانحراف وفريسة سهلة لشبكات الجريمة.
ومن تجاربهم القصيرة والمريرة في الحياة، يكبر هؤلاء الشباب، ويكبر معهم حقد دفين على مجتمعاتهم، وكره شديد للآخر ولأنفسهم، أو على الأقل لماضيهم القاسي الذي يسعون إلى التخلص منه، ذنباً ثقيلاً يحملونه فوق أكتافهم. لذلك، نجد عندهم هذا الاستعداد الكبير للتضحية بحياتهم، من أجل إعطائها “معاني” و”أهدافاً” لم ينجحوا في صنعها في حياتهم اليومية.
الملاحظة الأخرى التي يكاد الباحثون يجدونها عند كل هؤلاء “الجهاديين”، أو “الجهاديين المفترضين”، هي أنهم لا يتقنون العربية، ولم يتلقوا تعليماً دينياً أصيلا، وإنما تعليمات يرددونها مثل ببغاوات في لغة عربيةٍ، بلكنة غريبة، هي خليط من لكنتي شباب الضواحي والأعاجم.
ومن تتبع مسارات أغلب هؤلاء “الجهاديين”، نجد أن أغلبهم تمّت تعبئتهم في ظرف زمني، للتحول إلى أدوات للعنف والجريمة، ومدى علاقة ذلك بالخطاب الديني الذي يبرّرون به أفعالهم الإجرامية.
البحث عن جذور دوافع العنف والتطرف عند هؤلاء “الشباب” ليست دائماً دينية، لأن الشخصية العنيفة والميالة إلى العنف لا يمكن إعدادها في ظرف عدة أشهر أو أسابيع، فالأصل عند هؤلاء أن لهم شخصيات مضطربة، وغالباً ميالة إلى العنف، والخطاب الديني المتطرف الذي يتخذونه مطية لتنفيذ أفعالهم الإجرامية يأتي فقط لتبريرها، وإضفاء “شرعية” عليها، وأيضا لإعطائها “أهدافاً” دنيوية و”غايات” أخروية.
فالأصل عند هؤلاء “الجهاديين” هو خزان العنف الكامن في دواخلهم، وهو ترسبات وتراكمات مجتمعية وتربوية وثقافية وبيئية، ترسم ملامح شخصياتهم العنيفة والمتعطشة إلى استعمال العنف، للتفريغ والتعبير عن نفسها.
مثل هذه “الشخصية” المركبة والمعقدة تكون سهلة للتعبئة والشحن. لذلك، يقال إنه لو كنا، في عقد السبعينيات أو الثمانينيات، لكان هؤلاء الشباب حطب الحركات اليسارية الراديكالية التي كانت تتبنى العنف منهجاً في عملها السياسي في العالم، وفي أوروبا خصوصاً.
وبما أنهم ينطلقون من كرههم الآخر، ورفضهم مجمعاتهم، فإنهم يجدون في الصور النمطية التي تروج داخل مجتمعاتهم عن رفض تيارات يمينية وبعض وسائل الإعلام “الإسلام”، الصورة المثالية للقيم التي يبحثون عنها، أي صورة النموذج الآخر المضاد للنموذج الذي رفضهم، أو رفضوا هم الاندماج داخله.
وليس غريباً أن تستقطبهم اليوم حركات الإسلام السياسي التي تتبنى العنف، من جيل “القاعدة” إلى الجيل الجديد الذي يتبنى أفكار تنظيم “داعش”. ليست هذه التنظيمات سوى غطاء إيديولوجي للعنف الكامن في دواخل هؤلاء، يضفي عليه شرعيته، ويعطيه معنى وهدفا بالنسبة إليهم.
ومع الأسف، تستغل هذه التنظيمات المتطرفة، التي تبرر أعمالها بالإسلام، “حالة مرضية” عند هؤلاء الشباب بطريقة نفعية وبراغماتية بشعة، لتنفيذ أهداف سياسية شيطانية.
ما حصل هو أن التنظيمات الإرهابية التي تدّعي انتماءها إلى الإسلام هي التي وضعت “الإسلام” غطاء للعنف الكامن عند شباب منفصم الشخصية، متطرف تربّى في بيئة عنيفة. فالأمر لا يتعلق بتطرف طارئ على الإسلام، وإنما بأسلمة نوع جديد من التطرف الذي ولد وترعرع في ضواحي المدن الأوروبية، ليخلق وحوشاً بشرية متعطشة إلى الدماء، تضفي على أعمالها الإجرامية طابعاً “جهاديا” هو بريء منها.
علي أنوزلا


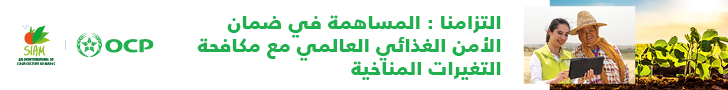

التعليقات مغلقة.