في التاريخ، ثمة وثائق تظل محتفظة بنضارتها رقم مرور السنوات والوقائع،وثائق تأبى الإحالة على التقادم والنسيان .
وثيقة 11 يناير 1944، تبقى من هذا النوع، الوثيقة التي خرجت من ذات بيت عتيق من احد الدروب الفاسية الضيقة، إلى كل شساعة التاريخ السياسي المعاصر لبلادنا، مدبجة بلغة القرويين ومذيلة بأسماء الموقعين، تبقى وثيقة بدون تجاعيد.
من معطف هذه الوثيقة الآسرة خرجت فصول أساسية من تاريخنا المغربي، وتقاطعت رهانات ومشاريع مختلفة، وعندما نقرأ اليوم لائحة الموقعين، نفكر حتما في تلك الإرادة التاريخية للنخبة الوطنية في صناعة التحول، غير أننا قد نتصور كذلك كيف اختلفت فيما بعد المصائر الفردية للذين اتفقوا على المطالبة باستقلال المغرب في 11 يناير 1944، بين الذين انصرفوا لنصيبهم من غنيمة مغرب ما بعد الاستقلال بكل اطمئنان و “وطنية” وبين الذين واصلوا النضال من أجل مضمون أكثر تحررا لاستقلال مبتور . بين الذين اختاروا ضفة السلطة الفتية، وبين الذين فضلوا تخصيب الفكرة الوطنية بالمطلب الديمقراطي والتقدمي، وبين الذين ركنوا للصمت والعيش على ذكرى توقيع بطعم الشرف .
بعد شهور من تقديم هذه الوثيقة، قام فصل آخر داخل الحركة الوطنية (رفاق محمد بلحسن الوزاني) بصياغة وتقديم وثيقة مشابهة، لكن هذه الأخيرة ظلت دون الحظوة التي سيحفظها التاريخ للوثيقة الأولى .
ومنذ ذلك التاريخ، جرت تحت جسر التاريخ المغربي، وثائق ومذكرات وبيانات بالعشرات، لكن وحدها وثيقة المطالبة بالاستقلال لعام 1944، ظلت تظفر “بحياة” تستحق التأمل.
الأكيد أن هذه الوثيقة، كثفت بشكل ما رمزية الحركة الوطنية، والأكيد كذلك هو أن روح الحركة الوطنية ظلت مستمرة حتى بعد استقلال 1956، في تحد واضح لاستشرافات وتكهنات الكثير من الأكاديميين الأجانب الذين تحدثوا بتسرع عن الموت البطيء للحركة الوطنية .
الحركة الوطنية التي وجدت نفسها على قارعة الطريق، بعد تحول 1960، بعيدة عن التأثير في مواقع القرار، لم تجد غير التاريخ لإعادة بناء شرعية وخطاب سياسي يمتحان من مرجعية النضال ضد الاستعمار، هكذا سيبدو المشروع السياسي للحركة الديمقراطية كامتداد تاريخي للمشروع الوطني لحركة التحرر .
من هنا ظلت الإحالة على التاريخ، وضمن هذا الأخير وثيقة المطالبة بالاستقلال، كاستثمار مستمر للشرعية الوطنية، وكبحث موصول عن منح المطلب الديمقراطي شرعية العمق التاريخي للحركة الوطنية.
حتى اليسار المغربي، كان وليدا طبيعيا لفكرة “الوطن” لا لفكرة “الطبقة” لذلك لم يستطع الخروج من معطف “الحركة الوطنية” وظل يطور خطاباته ومخياله الإيديولوجي وأفكاره وتمثلاته، من المرجعية الأم، المرجعية الوطنية، التي شكلت المعين الرئيسي لثقافته السياسية ولردود فعله الفكرية .
وهكذا ظل مشدودا لفكرة “الإصلاح” ولمنهجية “التوافق” في التدبير السياسي لمعارك مغرب الاستقلال، ولذلك ظل يحتفي – مع عموم القوى الديمقراطية – بذكرى تقديم الوثيقة، مسبغا عليها مضامين الحاضر ورهاناته، لذلك ربما اختارت الكتلة الديمقراطية أن تعلن برنامجها الإنقاذي، في منتصف التسعينات، في شكل بيان من أجل الديمقراطية، يوم 11 يناير بالضبط.
هذا اللجوء إلى التاريخ وهذه العودة المنظمة إلى لحظة النضال الوطني، هو ما جعل الوثيقة الشهيرة تبقى جزءا من الإحالات التاريخية الأكثر ترددا في الخطاب السياسي للمغرب المعاصر . خاصة عندما أصبحت تستعمل كذلك لإسناد مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية . حتى كادت تتحول كل الحاجة إلى هذه الإصلاحات داخل خطاب الحركة الوطنية إلى مجرد وفاء ضروري للشق الثاني من وثيقة 11 يناير بعد تحقق الشق الأول المرتبط بالاستقلال.
هل الأمر علاقة بأزمة في الخيال السياسي تجعل المطالبة بالديمقراطية لا تكتمل شرعيتها كدعوة سياسية إلا بالتذكير بشق غير متحقق في وثيقة تعود إلى سنوات الأربعينات ؟
أم أنه ثقل التاريخ في مجتمع لا يثق في المستقبل، مجتمع يحمل علاقة مرضية مع ماضيه، وهو ما يجعل الخطاب السياسي للنخبة يحمل هذا النفس الاستراتيجي للتاريخ، حيث المستقبل لا يوجد حتما خارج استعادة إحدى لحظات الماضي ؟
أتساءل، وأنا أفكر في بعض الباحثين الذين، تأسيسا على جهد تنقيبي، شككوا أساسا في وجود شق ثان يتحدث عن تأسيس نظام ديمقراطي داخل الصيغة الأصيلة لوثيقة المطالبة بالاستقلال.
ولعل هذا ما يقترب من سقف “الممكن” و”الفكر فيه ” لدى النخبة السياسية للحركة الوطنية خلال سنة 1944، ومن روح المرحلة .
ولعل هذا ما يفسر لماذا قد يكون أقحم “الشق الثاني” في لحظة ما، بحثا عن شرعنة تاريخية لمطلب ينتمي إلى المستقبل!


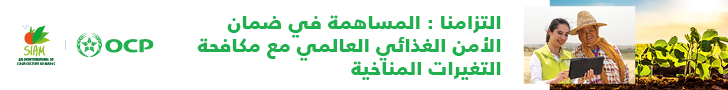

التعليقات مغلقة.