أثارت الأغنية الأخيرة للمغنية “الداودية” كثيرا من الجدل وردود الأفعال، بين مؤيد ومعارض، لكن اللافت هو أن الأغنية حظيت بمتابعة أكثر من مليوني مغربي ومغربية عبر “اليوتيوب”، وهو رقم كبير يحمل أكثر من دلالة. وبغض النظر عن الأصوات التي انتقدت بشدة الأغنية، واعتبرتها تحريضا فاضحا على التحرش الجنسي، من خلال كلماتها “السوقية”، فإن عدد غير قليل من المغاربة أبدوا إعجابهم بها، وقد تجد منهم حتى بعض الذين تظاهروا بالرفض، وهذا ما يطرح علينا كمجتمع سؤالا: لماذا هذا الاختلاف حول أغنية؟ وما هي خلفيات ذلك؟ وكيف نزل الذوق العام إلى هذا الحضيض حتى أصبحنا “نستهلك” كل ما يُقدّم لنا من أعمال لا تحمل أي قيمة فنية؟ وهل أصيبت عقولنا وأحاسيسنا بالتبلد إلى الحدّ الذي لم تعد تفرق بين الغث والسمين؟ الحقيقة، أن الذين هاجموا الأغنية وصاحبتها، وإن كنا نتفهم غيرتهم على الذوق العام من جهة، وعلى صورة المرأة المغربية التي أساءت إليها، وقدمتها كجسد لإثارة الرجال، إلا أنه لا ينبغي أن يلوموا صاحبة الأغنية، بل يجب أن يعاتبوا المجتمع الذي سمح للأغاني الهابطة بأن تقتحم البيوت والفضاءات العامة، ويسائلوا المؤسسات المعنية بالترويج لهذه الأعمال الرديئة، لأنه في النهاية لو لم يكن هناك طلب على تلك الأغاني، لما كان لها أن تجد سوقا رائجة ببلادنا، الفن عموما هو انعكاس لما يروج في المجتمع، وكما يقول المثل: “كُلّ إناء بما فيه ينْضَحُ”. والقضية، وإن كانت مرتبطة بالمجال الفني، فإن لها أبعادا سياسية واقتصادية، لأنه إذا كان الفساد في المغرب يخترق المجال السياسي والإداري، فهو قد أتى على جميع المجالات الحيوية ذات التأثير في المجتمع، وعلى رأسها المجال الثقافي والفني، وأتذكر هنا اعترافا للمغنية نجاة اعتابو في حوار لها مع إحدى الصحف، تعبر فيه عن امتعاضها من سقوط ما يسمى بـ”الأغنية الشعبية” في الابتذال، وأنه كان يُطلب منها أن تقدم أغاني تهيج الناس وترقّصهم.. والأدهى أن يمتد هذا الإفساد والبذاءة، إلى المجال السياسي، حيث أصبح جزء من النخب السياسية لا تحسن التخاطب والتواصل والتنابز إلا بالألفاظ السوقية والكلمات المبتذلة، التي لم نكن نسمعها إلا في الشارع، فدخلت إلى البيوت عبر الأفلام والبرلمان.. على ماذا يدّل ذلك؟ يدل على أن هناك لوبيات للفساد، تستغل الفقر والجهل والأمية وتراجع القيم والأخلاق في المجتمع، لترويج وتسويق أعمال وإنتاجات تسمم مجالات الإبداع عموما، والثقافة والفن بشكل خاص، وإفساد الذوق العام، وإعطاب الأحاسيس، موظفة في ذلك الأموال والنفوذ من أجل سيادة نمط معين من الغناء لا طعم له ولا لون ولا رائحة، ونشره في الأوساط الشعبية، وهو ما يُطلق عليه بـ”الأغنية الشعبية”، التي تعتمد مواضيع تافهة، ولغة الشارع، وألحان وإيقاعات مثيرة ومهيجة، وهي موجهة بالأساس إلى الفئات الشعبية الفقيرة والأمية أو التي لم تكمل تعليمها، وتلقى رواجا في السوق، وتحظى بدعم شركات الإنتاج .. بخلاف الأغاني العصرية أو الكلاسيكية، وهذا ما أكدته “الداودية” في أحد البرامج التلفزية، حين اعترفت بحبها لأغاني الراي، لكنها توجهت “للأغنية الشعبية”، لأنها تحقق الشهرة وتجني أرباحا كبيرة، مثل المغاربة الذين اختاروا الغناء في المشرق من أجل الشهرة والمال..
وهنا لا بد من الاعتراف بأن الظروف الاجتماعية والأسرية الصعبة في كثير من الحالات قد تضطر بعض المغاربة لاختيار لون معين من الغناء، وهذا ما ينطبق على “الداودية”، حيث من يطلع على ظروفها، يلتمس لها العذر، خاصة وأنها عاشت تجربة أليمة بعد تخلي أسرتها عليها في سن صغيرة لرغبتها في الغناء، كونها أسرة محافظة وملتزمة دينيا، وتركتها إلى مصير مجهول وهي لم تصل بعد لسن الرشد، وهذا لا شك جعلها تعاني لكي تثبت ذاتها، في المجال الذي أحبته، وطبعا هذه الظروف الصعبة لا تعفيها من المسؤولية عن اختيارها هذا الطريق، لكن عندما تجتمع عوامل الفقر بالحرمان الأسري والقصور وقلة التجربة وضعف التعليم.. فإنها لا يمكن إلا أن تنتج لنا نماذج أخرى من “الداودية..
لكن الجميل بعد كل هذه المعاناة، رغم قسوة الأهل والمجتمع، ظل جوهر “هند الحنوني” هو أنها المرأة المسلمة، التي تحن إلى القيم المثلى التي تربت عليها، لأنها في أكثر من مرة عبّرت عن رغبتها في اعتزال الغناء، لكن في المرة الأخيرة أكدت رغبتها السابقة مع الوفاة بالكعبة، ربما للتكفير عن ما تحس به من ذنب، لأنها تدرك جيدا أنها ليست في الطريق الصحيح، خاصة أن الغناء الذي تقدمه، لا علاقته له بالأخلاق وبقيم المجتمع، كما تعني أنها لا زالت تحمل بذرة الخير التي زرعتها الأسرة، والشوق إلى إعادة السكينة للروح، والأمان للنفس، والراحة للضمير، والتي لم ولن يحققها المال والشهرة. قد يعتبر بعض المتحاملين، كلام “هند الحنوني” تعبير عن تناقض وفصام وازواجية، لأنها تؤمن بقيم ومبادئ ولا تطبقها في حياتها، وهو ما يعكس النفاق الاجتماعي، الذي يتميز به كثير من المغاربة، لكن الحقيقة أن هند هي إنسان، والإنسان بطبيعته له ميول للخير وللشر معا، وهي أيضا جزء من هذا المجتمع المسلم، الذي كشف استطلاع للرأي قام به مركز “بيو” الأمريكي في 2012، أن 89% من المغاربة يعتبرون الدين مهما في حياتهم، لكن المشكل يكمن في أن التمثّل الخاطئ لأحكام الدين لدى الناس، بسبب غياب التأطير الديني الصحيح سواء داخل الأسر أو في المساجد أو المدارس أو الإعلام.. هو الذي يجعل معظم الناس تعيش في تناقض بين ما تؤمن به وما تمارسه في الواقع، تلخصها بعض المقولات الخاطئة مثل (الإيمان فالقلب) والصواب هو (الإيمان ما وَقَرَ في القلب وصدّقه العمل)، و(شويّا لربيّ وشويّا لعبدو) والصواب (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، (ولا حياء في الدين)، والصواب (أن الحياء شعبة من شعب الإيمان)، والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لحصرها.
هذا التمثل والتصور الذهني الخاطئ للدين، أصبح يطغى على سلوك الناس، بحيث كثيرا ما نجد أناس يصلون ويصومون، وفي نفس الوقت مدمنون على القمار أو على الخمر أو على الزنا أو غير ذلك من الأفعال المحرمة، وهؤلاء يدركون أن عملهم محرم شرعا، لكنهم لا يستطيعون الإقلاع عنها بسبب سيطرة الهوى، والجهل بالدين، والرفقة السيئة، لأن هناك من يعتقد أن الدين هو القيام بالشعائر التعبدية الظاهرية، وبمجرد ما ينتهي منها، يتحلل من كل التزام بالدين في حياته، لأنه يعتبره مجرد عبادات ولا علاقة له بالمعاملات اليومية، في حين أن (الدين المعاملة) كما ورد في الأثر النبوي، ومن ذلك التمثل أيضا، نجد بعض الفتيات يرغبن في الجمع بين أمرين على طرفي نقيض، لبس “الحجاب” مختزلا في غطاء الرأس، وإظهار الأنوثة من خلال اللباس المثير.. صحيح أن الإنسان خطّاء، وخير الخطائين التوابون، ولا أحد معصوم من الوقوع في المعاصي، لكن هناك فرق بين من يقع في المعاصي لضعف إيماني وغلبة الهوى، لكن يظل ضميره يؤنّبه، ويجاهد نفسه لكي يتوب، وبين الذي يرتكب المعاصي بطواعية ودون إحساس بالذنب، ومن غير أدنى مقاومة لهوى النفس والشيطان، فالأول يجتهد لكي تصبح أفعاله منسجمة مع أقواله، أما الثاني فلديه الإصرار على التمادي في الخطأ، وهو ما يجعله بعيدا عن سلوك طريق الرشد والهداية، فيكون غالب سلوكه مناقض لقناعاته، عكس الأول. وإذا كانت “هند الحنوني” الإنسانة قد أصابت روحها لوعة الشوق إلى ربّها، فهذا لا يحتاج منها إلا إلى قرار جريء وسريع، لأن التأجيل من استدراج إبليس، يُمنّي النفس ويعلق توبتها بأمر معين، حتى يفوّت عليها الفرصة إلى أن يداهمها الموت، والإنسان لا يضمن بقاءه على قيد الحياة للحظة، فكيف يمكن المغامرة بتأجيل التوبة إلى أجل غير مسمى، حتى تستطيع العيش في انسجام ووئام مع ذاتها، بالقيم والمبادئ التي تؤمن بها.


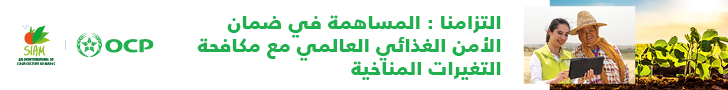

التعليقات مغلقة.